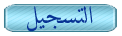الإسرائيليات في التراث العربي الإسلامي :
قد يقول قائل: إن قصص القرآن الكريم معروفة ومدروسة خلال أربعة عشر قرناً، ولا حاجة بالتالي إلى قراءتها - كما تدعو- قراءة جديدة ، فأجيبه: إنني أدعو إلى الانطلاق في دراسة القصص القرآني من المبدأ التالي: يتجلى إعجاز القرآن الكريم في أن القصص القرآني لا يفتقر إلى شرح وتفسير من خارج القرآن نفسه ؛ لذا أرفض قراءة القصص القرآني في ضوء الروايات التوراتية حول القصص نفسها، أو في ضوء القصص أو الأساطير المماثلة أو الشبيهة عند الشعوب القديمة السابقة لعصر نزول القرآن ، وأدعو إلى (قراءة جديدة) للقصص القرآني تقتصر على الرجوع فقط إلى القصص كما وردت في نص المصحف الشريف، وتدرسها بالاستناد إلى معرفة جيدة باللسان العربي الذي أنزل القرآن به ، وبذا تسهم دعوتي هذه إلى قراءة جديدة للقصص القرآني في التحرر من (الإسرائيليات) التي عششت في التراث العربي الإسلامي.
ومن الطبيعي أن يطرح هنا التساؤل التالي: كيف تولّد في التراث العربي الإسلامي ما صار يطلق عليه فيما بعد تسمية (الإسرائيليات)؟ .
أفرد د. جواد علي في كتابه "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"(1)، في الجزء الأول فصلاً عنوانه (أثر التوراة على روايات أهل الأنساب والأخبار في أنساب العرب) (2 ) فذكر أن ما جاء من القصص في القرآن الكريم مجملاً من أمر آدم ونوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرهم، وما جاء من أمر عاد وثمود وقوم صالح وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع، كان له أثر كبير في أهل الأخبار والتفسير حملهم على البحث عنهم والتفتيش عن أخبارهم من الأحياء المسنين الذين كانوا يقصون على جيلهم قصص الماضين وأخبار العرب المتقدمين، ومن أهل الكتاب الذين كان لهم إلمام بما جاء في التوراة من الرسل والأنبياء والأمم والأنساب.
أما الأماكن التي ظهرت فيها هذه الروايات الإسرائيلية كانت اليمن والمدينة والعراق (وبصورة خاصة الكوفة) حيث كان في كل هذه المواضع رجال من أهل الكتاب موّنوا أهل الأخبار بما كانوا يرغبون في معرفته.
لقد كان (محمد بن إسحاق بن يسار) صاحب "المغازي والسير"(3) من الآخذين عن أهل الكتاب الراوين عنهم: وكان يسميهم أهل العلم الأول.
ويروي المؤرخون والإخباريون ما ورد من قصص توراتي ، ومن أنساب توراتية عنه ، وبذا كان ابن إسحاق أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين ، كما كان (هشام بن محمد بن السائب الكلبي) من الآخذين عن أهل الكتاب كذلك، المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة إلى المسلمين.
فكان لهما أثر بارز فيمن جاء بعدهما في موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة. ونبه د / جواد علي إلى أن ما نسب إلى (ابن عباس) من أقوال لها صلة بالتوراة يجب دراسته بحذر ونقده نقداً علمياً.
وفي ضوء ما عرضناه بإيجاز شديد لما أطلق عليه في التراث العربي الإسلامي تسمية (الإسرائيليات)، يتضح لماذا أرفض (القراءة القديمة) للقصص القرآني التي تعتمد الروايات التوراتية (الإسرائيليات) أساساً لفهم القصص القرآني، بحجة شرحها ووصف تفاصيلها، ويتضح السبب في دعوتي إلى (قراءة جديدة) للقصص القرآني متحررة من الإسرائيليات التي سيطرت عليها على مر القرون.
وأرى أن القراءة الجديدة للقصص القرآني يجب أن تقتصر على الرجوع فقط إلى القصص كما وردت في نص المصحف الشريف ، وتقوم بدراستها دراسة لغوية- أدبية أو لغوية- علمية حسب موضوعها، وذلك استناداً إلى اللسان العربي وخصائصه وأساليبه.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن دعوتنا إلى قراءة جديدة للقصص القرآني تُفضي إلى فصل دراسة القصص القرآني عن قصص التوراة ، وننبّه إلى أن الدعوة إلى فصل دراسة القصص القرآني عن الروايات التوراتية حول القصص نفسها، أو عن الروايات في القصص أو الأساطير المماثلة أو الشبيهة عند الشعوب القديمة السابقة لعصر نزول القرآن الكريم، تستهدف أول ما تستهدف - بعد جمع آيات كل قصة من القصص في القرآن كما وردت في نص المصحف الشريف وحده- دراسة هذه القصص بالاستناد إلى اللسان العربي وخصائصه وأساليبه.
وبعد إنجاز هذه القراءة الجديدة لقصص القرآن الكريم، يصبح مفيداً للتاريخ الحضاري الإنساني مقارنة قصص القرآن الكريم بالروايات التوراتية حول القصص نفسها، وكذا مقارنتها بالروايات في القصص أو الأساطير المماثلة أو الشبيهة عند الشعوب القديمة.
الأدلة الإيمانية والأدلة العلمية:
ولابد هنا من التنبيه أيضاً إلى ضرورة عدم الخلط بين الأدلة المستندة إلى الكتب المقدسة وبين الأدلة العقلية ، فالأدلة المستندة إلى نصوص الكتب المقدسة يؤكد صحتها الإيمان بها (والإيمان شأن ذاتي خاص بكل إنسان)، لذا يقبل بها المؤمنون وحدهم ولا تُلزم غيرهم القبول بها ، أما الأدلة العقلية فيؤكد صحتها العقل الإنساني بصرف النظر عن الإيمان بالكتب المقدسة أو عدم الإيمان بها ( والعقل بهذا المعنى شأن موضوعي يشترك فيه الناس جميعاً) لذا يقبل بها الناس كلهم: سواء أكانوا مؤمنين (على اختلاف دياناتهم) أم غير مؤمنين.
وعليه نصف الأدلة المستندة إلى الكتب المقدسة بأنها أدلة إيمانية، ونصف الأدلة العقلية بأنها أدلة علمية.
ونخلص من ذلك إلى أن نصوص (الكتب المقدسة) في الديانات جميعها (السماوية وغير السماوية) ليست أدلة علمية بل أدلة إيمانية ، وهي لذلك تلزم المؤمنين بها وحدهم، وليست حجة بالنسبة إلى غيرهم ، ولا يصح بالتالي النظر إلى نصوص الكتب المقدسة- مهما كان مصدرها ومهما اشتملت عليه من العلم والحكمة- على أنها نصوص علمية في التاريخ أو اللسانيات أو الطب أو الجيولوجيا أو بقية فروع العلم.
في إعجاز القرآن الكريم :
ذكر السكاكي في "مفتاح العلوم" (4) أن قارعي باب الاستدلال، بعد الاتفاق أنه معجز، مختلفون في وجه الإعجاز:
أ- فمنهم من يقول: وجه الإعجاز هو أنه عز سلطانه صرف المتحدين لمعارضة القرآن عن الإتيان بمثله بمشيئته.
ب- ومنهم من يقول: وجه إعجاز القرآن وروده على أسلوب مبتدئ ، مباين لأساليب كلامهم في خطبهم وأشعارهم، لاسيما في مطالع السور ومقاطع الآي.
ج- ومنهم من يقول: وجه إعجازه سلامته عن التناقض.
د- ومنهم من يقول: وجه الإعجاز الاشتمال على الغيوب.
هـ- فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة.
هذا وقد لخص السيوطي، في كتابه "الإتقان من علوم القرآن"(5) الآراء المختلفة حول إعجاز القرآن.
وتجدر الإشارة هنا إلى "أنه كان للمتكلمين الدور الأكبر في تاريخ دراسة إعجاز القرآن الكريم ، ومع ذلك يغفل عدد من الباحثين المعاصرين فضل المتكلمين في هذا المضمار، كما يتم بشكل عام إغفال دور المتكلمين الإيجابي في علم اللغة العربية(6).
وأقتبس فقرة كتبها الأستاذ مناع القطان في كتابه "مباحث في علوم القرآن" في فصل (إعجاز القرآن)(7)، جاء فيها ما يلي: "لقد كان لنشأة علم الكلام في الإسلام أثر أصدق ما يقال فيه: أنه كلام في كلام ، وما فيه من وميض التفكير يجر متتبعه إلى مجاهل من القول بعضها فوق بعض، وقد بدأت مأساة علماء الكلام في القول بخلق القرآن، ثم اختلفت آراؤهم وتضاربت في وجوه إعجازه".
في "دلائل الإعجاز" يناقش الجرجاني في فصل خاص( معنى التحدي بالإعجاز، فيقول: "يقال لهم: إنكم تتلون قول الله تعالى "قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله"(*) وقوله عز وجل "قل فأتوا بعشر سور مثله"(**) وقوله "بسورة مثله"(***)فقولوا الآن: أيجوز أن يكون الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتحدى العرب إلى أن يعرضوا القرآن بمثله من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك الوصف كانوا قد أتوا بمثله؟ ولابد من (لا) لأنهم إن قالوا: يجوز، أبطلوا التحدي من حيث إن التحدي كما لا يخفى مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصف، ولا تصح المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف معلوماً للمطالب ، ويبطل بذلك دعوى الإعجاز أيضاً..".
معنى التحدي بالإعجاز، فيقول: "يقال لهم: إنكم تتلون قول الله تعالى "قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله"(*) وقوله عز وجل "قل فأتوا بعشر سور مثله"(**) وقوله "بسورة مثله"(***)فقولوا الآن: أيجوز أن يكون الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتحدى العرب إلى أن يعرضوا القرآن بمثله من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك الوصف كانوا قد أتوا بمثله؟ ولابد من (لا) لأنهم إن قالوا: يجوز، أبطلوا التحدي من حيث إن التحدي كما لا يخفى مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصف، ولا تصح المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف معلوماً للمطالب ، ويبطل بذلك دعوى الإعجاز أيضاً..".
ويخلص الجرجاني من ذلك إلى القول : إن الوصف بالإعجاز "ينبغي أن يكون وصفاً قد تجدد بالقرآن ، وأمراً لم يوجد في غيره ، ولم يعرف قبل نزوله" ويقرر الجرجاني في ضوء ذلك أن الوصف بالإعجاز لا يجوز أن يكون:
آ) في الكلم المفردة.
ب) في تركيب الحركات والسكنات.
جـ) في المقاطع والفواصل.
د) بأن لا يكون في حروفه ما يثقل على اللسان.
كما يرفض الجرجاني القول بالصرفة، ويرفض القول بأن الوصف بالإعجاز هو في غريب القرآن ، ويمكن تلخيص رأي الجرجاني في إعجاز القرآن بما يلي:
1ـ أن الوصف الذي له كان القرآن معجزاً- وهو الفصاحة والبلاغة- قائم فيه أبداً ، والطريق إلى العلم به موجود والوصول إليه ممكن.
2ـ لابد من الرجوع إلى علم النحو والشعر العربي من أجل الكشف عن إعجاز القرآن.
3ـ لا ترتبط البلاغة بالكلمة المفردة دون اعتبارها في النظم ، ويجب أن يتوافر في الكلام البليغ عنصران: حسن الدلالة وتبرجها في صورة بهية ، لذا يظهر إعجاز القرآن في مزايا نظمه وخصائص سياق لفظه.
4ـ ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، كما أن الاستعارة وسائر ضروب المجاز من مقتضيات النظم ، وعنها يحدث وبها يكون ، وهذا يعني أنه لا يجوز فصل النحو عن البلاغة.
الصياغة القرآنية المعجزة :
إننا نتبنى رأي عبد القاهر في الإعجاز القرآني ، واستناداً إلى منهجنا الوصفي الوظيفي في الدراسة اللغوية الأدبية( الذي يؤكد تلازم اللفظ والمعنى ويرفض بالتالي القول بالترادف"، نرى أن الإعجاز القرآني يتجلى بالضرورة في صياغة قرآنية معجزة. ولكن: ما السرّ في تمتع القرآن الكريم بصياغة معجزة؟
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل ، لذا فإن القرآن الذي أنزل إليه تميز عن جميع ما نزّل الله على الأنبياء والرسل قبله بأنه التنزيل الأخير من الله إلى الناس إلى يوم البعث ، واستوجب ذلك أن يكون كتاب التنزيل الأخير (القرآن) متمتعاً بصياغة معجزة تؤكد صلاحيته لكل مكان وزمان إلى يوم الدين، على الرغم من ثبات آياته في مبناها وعدم تحوير صياغتها.
كان كتاب التنزيل الأخير (القرآن) كتاب دين الله (الإٍسلام): "إن الدين عند الله الإسلام.." (آل عمران/19). وفي كتاب التنزيل الأخير (القرآن)، أعلن الله للناس أنه أكمل لهم دينهم وأتمّ عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام ديناً: "... اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تَخشَوْهم واخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.." (المائدة/3).
ولقد وُصف القرآن بأنه الذكر الذي تعهد الله بحفظه: "إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون" (الحجر/9) لذا فإن آياته ثابتة ثبوتاً يقينياً في مبناها (نطقاً في الأصل ثم دوّنت فيما بعد كتابة)، وباقية كما أنزلت وحياً على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحوير في صياغتها أبداً.
إن الصياغة المعجزة للآيات التي يتكوّن منها القرآن الكريم هي التي تجعله صالحاً لكل مكان وزمان إلى يوم الدين، والصياغة المعجزة تستلزم بالضرورة أن تتمتع آيات القرآن الكريم بخاصتي الثبات والتحول معاً (الثبات في المبنى والتحول في المعنى).
وتظهر الصياغة المعجزة لآيات القرآن الكريم في أنها على الرغم من تمتعها بخاصية الثبات في المبنى التي أشرنا إليها، هي في الوقت نفسه تتمتع بخاصية التحول في معناها الذي يفهمه الناس كل حسب معارف عصره وعلومه ، وهذا هو وجه الإعجاز الأكبر لآيات القرآن الكريم الذي يجعلها صالحة لكل زمان ومكان.
إن مثل هذه الصياغة التي تتمتع بخاصتي الثبات في المبنى والتحول في المعنى معاً فوق قدرات الإنسان ، ومعارفه المحدودة بعلوم عصره ، وهذه الصياغة التي يعجز عن مثلها الناس دليل علمي قاطع على أن "مؤلفها" منْ هو أعلم من الناس وأقدر- الله تعالى.
ومن هذا الفهم لوجه الإعجاز الأكبر في القرآن الكريم، تظهر الحاجة إلى التجديد المستمر في الدراسات القرآنية، لتأويل الآيات بما يظهر صلاحيتها دائماً لجميع الأمكنة والأزمنة وفق حاجات كل عصر ، وفي ضوء المعارف السائدة فيه ، والتطور العلمي الذي بلغه.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود فرق كبير بين (التفسير) و(التأويل) فالتفسير في اللغة يرجع إلى معنى الإظهار والكشف ، أما معنى قولهم (ما تأويل هذا الكلام؟) أي (إلامَ تؤول العاقبة في المراد به؟) ومن هنا فالتأويل هو المراد بالكلام نفسه ، فتأويل الطلب هو الفعل المطلوب نفسه، وتأويل الخبر هو الشيء المخبر به نفسه.
وعلى هذا يكون الفرق كبيراً بين التفسير والتأويل ، فالتفسير شرح وإيضاح للكلام، ويكون وجوده في الذهن بتعقله، وفي اللسان بالعبارة الدالة عليه ، أما التأويل فهو الأمور الموجودة في الخارج نفسها، فإذا قيل (طلعت الشمس) فتأويل هذا هو (طلوعها نفسه)، وقد قيل : إن التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظ ومفرداتها، والتأويل أكثر ما يستعمل في المعاني والجمل.
وما دام القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، فهو لا يحتاج إلى تفسير وإنما يحتاج إلى تأويل ، والتأويل يتعلق بالاشتراك اللفظي ، والاشتراك في اللغة هو دلالة اللفظة الواحدة على عدة معان مختلفة، وميدانه الآيات المتشابهات ، أما التفسير فيتعلق بالترادف ، والترادف في اللغة هو دلالة الألفاظ المختلفة على المعنى الواحد ، إننا نرفض القول بالترادف في اللسان العربي ، وفي القرآن الكريم ، وعليه نرى أن لا ترادف بين ألفاظ القرآن الكريم، وأن كل لفظة وضعت لتؤدي معنى دقيقاً محكماً.
وهكذا يظهر أن مصطلح (التأويل) الذي يراه العامة من الناس أمراً مستهجناً ليس في الحقيقة كذلك عند أهل اللغة والرأي والبيان، بل هو أمر مطلوب. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن العلماء الأوائل سمّوا أغلب دراساتهم للقرآن الكريم تأويلاً له ، ثم جاء المتأخرون وغيّبوا من عناوين تلك الدراسات القرآنية مصطلح (التأويل) وأدخلوا بدلاً منه مصطلح (التفسير) من دون إدراك للفرق بينهما ، فصاروا يقولون : (تفسير النسفي) وعنوانه الأصلي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أو (تفسير البيضاوي) وعنوانه الأصلي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل).
إن مثل هذا التصرف برأيي إجحاف في حق القرآن الكريم واللغة والبلاغة والعلم ، وهذه مجموعة من العناوين التي تم تغييرها بإحلال لفظة (التفسير) بدلاً من (التأويل).
- "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل" للإمام جار الله الزمخشري.
- "جامع البيان في تأويل القرآن" للإمام الطبري.
- "لبان التأويل في معاني التنزيل" للإمام الخازن.
- "محاسن التأويل" لجمال الدين القاسمي.
دعوتنا إلى قراءة جديدة للقصص القرآني تستند إلى رأينا في تلازم التحدي بالإعجاز والتجديد في الدراسات القرآنية.
قد يقول قائل: إن قصص القرآن الكريم معروفة ومدروسة خلال أربعة عشر قرناً، ولا حاجة بالتالي إلى قراءتها - كما تدعو- قراءة جديدة ، فأجيبه: إنني أدعو إلى الانطلاق في دراسة القصص القرآني من المبدأ التالي: يتجلى إعجاز القرآن الكريم في أن القصص القرآني لا يفتقر إلى شرح وتفسير من خارج القرآن نفسه ؛ لذا أرفض قراءة القصص القرآني في ضوء الروايات التوراتية حول القصص نفسها، أو في ضوء القصص أو الأساطير المماثلة أو الشبيهة عند الشعوب القديمة السابقة لعصر نزول القرآن ، وأدعو إلى (قراءة جديدة) للقصص القرآني تقتصر على الرجوع فقط إلى القصص كما وردت في نص المصحف الشريف، وتدرسها بالاستناد إلى معرفة جيدة باللسان العربي الذي أنزل القرآن به ، وبذا تسهم دعوتي هذه إلى قراءة جديدة للقصص القرآني في التحرر من (الإسرائيليات) التي عششت في التراث العربي الإسلامي.
ومن الطبيعي أن يطرح هنا التساؤل التالي: كيف تولّد في التراث العربي الإسلامي ما صار يطلق عليه فيما بعد تسمية (الإسرائيليات)؟ .
أفرد د. جواد علي في كتابه "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"(1)، في الجزء الأول فصلاً عنوانه (أثر التوراة على روايات أهل الأنساب والأخبار في أنساب العرب) (2 ) فذكر أن ما جاء من القصص في القرآن الكريم مجملاً من أمر آدم ونوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرهم، وما جاء من أمر عاد وثمود وقوم صالح وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع، كان له أثر كبير في أهل الأخبار والتفسير حملهم على البحث عنهم والتفتيش عن أخبارهم من الأحياء المسنين الذين كانوا يقصون على جيلهم قصص الماضين وأخبار العرب المتقدمين، ومن أهل الكتاب الذين كان لهم إلمام بما جاء في التوراة من الرسل والأنبياء والأمم والأنساب.
أما الأماكن التي ظهرت فيها هذه الروايات الإسرائيلية كانت اليمن والمدينة والعراق (وبصورة خاصة الكوفة) حيث كان في كل هذه المواضع رجال من أهل الكتاب موّنوا أهل الأخبار بما كانوا يرغبون في معرفته.
لقد كان (محمد بن إسحاق بن يسار) صاحب "المغازي والسير"(3) من الآخذين عن أهل الكتاب الراوين عنهم: وكان يسميهم أهل العلم الأول.
ويروي المؤرخون والإخباريون ما ورد من قصص توراتي ، ومن أنساب توراتية عنه ، وبذا كان ابن إسحاق أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين ، كما كان (هشام بن محمد بن السائب الكلبي) من الآخذين عن أهل الكتاب كذلك، المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة إلى المسلمين.
فكان لهما أثر بارز فيمن جاء بعدهما في موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة. ونبه د / جواد علي إلى أن ما نسب إلى (ابن عباس) من أقوال لها صلة بالتوراة يجب دراسته بحذر ونقده نقداً علمياً.
وفي ضوء ما عرضناه بإيجاز شديد لما أطلق عليه في التراث العربي الإسلامي تسمية (الإسرائيليات)، يتضح لماذا أرفض (القراءة القديمة) للقصص القرآني التي تعتمد الروايات التوراتية (الإسرائيليات) أساساً لفهم القصص القرآني، بحجة شرحها ووصف تفاصيلها، ويتضح السبب في دعوتي إلى (قراءة جديدة) للقصص القرآني متحررة من الإسرائيليات التي سيطرت عليها على مر القرون.
وأرى أن القراءة الجديدة للقصص القرآني يجب أن تقتصر على الرجوع فقط إلى القصص كما وردت في نص المصحف الشريف ، وتقوم بدراستها دراسة لغوية- أدبية أو لغوية- علمية حسب موضوعها، وذلك استناداً إلى اللسان العربي وخصائصه وأساليبه.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن دعوتنا إلى قراءة جديدة للقصص القرآني تُفضي إلى فصل دراسة القصص القرآني عن قصص التوراة ، وننبّه إلى أن الدعوة إلى فصل دراسة القصص القرآني عن الروايات التوراتية حول القصص نفسها، أو عن الروايات في القصص أو الأساطير المماثلة أو الشبيهة عند الشعوب القديمة السابقة لعصر نزول القرآن الكريم، تستهدف أول ما تستهدف - بعد جمع آيات كل قصة من القصص في القرآن كما وردت في نص المصحف الشريف وحده- دراسة هذه القصص بالاستناد إلى اللسان العربي وخصائصه وأساليبه.
وبعد إنجاز هذه القراءة الجديدة لقصص القرآن الكريم، يصبح مفيداً للتاريخ الحضاري الإنساني مقارنة قصص القرآن الكريم بالروايات التوراتية حول القصص نفسها، وكذا مقارنتها بالروايات في القصص أو الأساطير المماثلة أو الشبيهة عند الشعوب القديمة.
الأدلة الإيمانية والأدلة العلمية:
ولابد هنا من التنبيه أيضاً إلى ضرورة عدم الخلط بين الأدلة المستندة إلى الكتب المقدسة وبين الأدلة العقلية ، فالأدلة المستندة إلى نصوص الكتب المقدسة يؤكد صحتها الإيمان بها (والإيمان شأن ذاتي خاص بكل إنسان)، لذا يقبل بها المؤمنون وحدهم ولا تُلزم غيرهم القبول بها ، أما الأدلة العقلية فيؤكد صحتها العقل الإنساني بصرف النظر عن الإيمان بالكتب المقدسة أو عدم الإيمان بها ( والعقل بهذا المعنى شأن موضوعي يشترك فيه الناس جميعاً) لذا يقبل بها الناس كلهم: سواء أكانوا مؤمنين (على اختلاف دياناتهم) أم غير مؤمنين.
وعليه نصف الأدلة المستندة إلى الكتب المقدسة بأنها أدلة إيمانية، ونصف الأدلة العقلية بأنها أدلة علمية.
ونخلص من ذلك إلى أن نصوص (الكتب المقدسة) في الديانات جميعها (السماوية وغير السماوية) ليست أدلة علمية بل أدلة إيمانية ، وهي لذلك تلزم المؤمنين بها وحدهم، وليست حجة بالنسبة إلى غيرهم ، ولا يصح بالتالي النظر إلى نصوص الكتب المقدسة- مهما كان مصدرها ومهما اشتملت عليه من العلم والحكمة- على أنها نصوص علمية في التاريخ أو اللسانيات أو الطب أو الجيولوجيا أو بقية فروع العلم.
في إعجاز القرآن الكريم :
ذكر السكاكي في "مفتاح العلوم" (4) أن قارعي باب الاستدلال، بعد الاتفاق أنه معجز، مختلفون في وجه الإعجاز:
أ- فمنهم من يقول: وجه الإعجاز هو أنه عز سلطانه صرف المتحدين لمعارضة القرآن عن الإتيان بمثله بمشيئته.
ب- ومنهم من يقول: وجه إعجاز القرآن وروده على أسلوب مبتدئ ، مباين لأساليب كلامهم في خطبهم وأشعارهم، لاسيما في مطالع السور ومقاطع الآي.
ج- ومنهم من يقول: وجه إعجازه سلامته عن التناقض.
د- ومنهم من يقول: وجه الإعجاز الاشتمال على الغيوب.
هـ- فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة.
هذا وقد لخص السيوطي، في كتابه "الإتقان من علوم القرآن"(5) الآراء المختلفة حول إعجاز القرآن.
وتجدر الإشارة هنا إلى "أنه كان للمتكلمين الدور الأكبر في تاريخ دراسة إعجاز القرآن الكريم ، ومع ذلك يغفل عدد من الباحثين المعاصرين فضل المتكلمين في هذا المضمار، كما يتم بشكل عام إغفال دور المتكلمين الإيجابي في علم اللغة العربية(6).
وأقتبس فقرة كتبها الأستاذ مناع القطان في كتابه "مباحث في علوم القرآن" في فصل (إعجاز القرآن)(7)، جاء فيها ما يلي: "لقد كان لنشأة علم الكلام في الإسلام أثر أصدق ما يقال فيه: أنه كلام في كلام ، وما فيه من وميض التفكير يجر متتبعه إلى مجاهل من القول بعضها فوق بعض، وقد بدأت مأساة علماء الكلام في القول بخلق القرآن، ثم اختلفت آراؤهم وتضاربت في وجوه إعجازه".
في "دلائل الإعجاز" يناقش الجرجاني في فصل خاص(
ويخلص الجرجاني من ذلك إلى القول : إن الوصف بالإعجاز "ينبغي أن يكون وصفاً قد تجدد بالقرآن ، وأمراً لم يوجد في غيره ، ولم يعرف قبل نزوله" ويقرر الجرجاني في ضوء ذلك أن الوصف بالإعجاز لا يجوز أن يكون:
آ) في الكلم المفردة.
ب) في تركيب الحركات والسكنات.
جـ) في المقاطع والفواصل.
د) بأن لا يكون في حروفه ما يثقل على اللسان.
كما يرفض الجرجاني القول بالصرفة، ويرفض القول بأن الوصف بالإعجاز هو في غريب القرآن ، ويمكن تلخيص رأي الجرجاني في إعجاز القرآن بما يلي:
1ـ أن الوصف الذي له كان القرآن معجزاً- وهو الفصاحة والبلاغة- قائم فيه أبداً ، والطريق إلى العلم به موجود والوصول إليه ممكن.
2ـ لابد من الرجوع إلى علم النحو والشعر العربي من أجل الكشف عن إعجاز القرآن.
3ـ لا ترتبط البلاغة بالكلمة المفردة دون اعتبارها في النظم ، ويجب أن يتوافر في الكلام البليغ عنصران: حسن الدلالة وتبرجها في صورة بهية ، لذا يظهر إعجاز القرآن في مزايا نظمه وخصائص سياق لفظه.
4ـ ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، كما أن الاستعارة وسائر ضروب المجاز من مقتضيات النظم ، وعنها يحدث وبها يكون ، وهذا يعني أنه لا يجوز فصل النحو عن البلاغة.
الصياغة القرآنية المعجزة :
إننا نتبنى رأي عبد القاهر في الإعجاز القرآني ، واستناداً إلى منهجنا الوصفي الوظيفي في الدراسة اللغوية الأدبية( الذي يؤكد تلازم اللفظ والمعنى ويرفض بالتالي القول بالترادف"، نرى أن الإعجاز القرآني يتجلى بالضرورة في صياغة قرآنية معجزة. ولكن: ما السرّ في تمتع القرآن الكريم بصياغة معجزة؟
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل ، لذا فإن القرآن الذي أنزل إليه تميز عن جميع ما نزّل الله على الأنبياء والرسل قبله بأنه التنزيل الأخير من الله إلى الناس إلى يوم البعث ، واستوجب ذلك أن يكون كتاب التنزيل الأخير (القرآن) متمتعاً بصياغة معجزة تؤكد صلاحيته لكل مكان وزمان إلى يوم الدين، على الرغم من ثبات آياته في مبناها وعدم تحوير صياغتها.
كان كتاب التنزيل الأخير (القرآن) كتاب دين الله (الإٍسلام): "إن الدين عند الله الإسلام.." (آل عمران/19). وفي كتاب التنزيل الأخير (القرآن)، أعلن الله للناس أنه أكمل لهم دينهم وأتمّ عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام ديناً: "... اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تَخشَوْهم واخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.." (المائدة/3).
ولقد وُصف القرآن بأنه الذكر الذي تعهد الله بحفظه: "إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون" (الحجر/9) لذا فإن آياته ثابتة ثبوتاً يقينياً في مبناها (نطقاً في الأصل ثم دوّنت فيما بعد كتابة)، وباقية كما أنزلت وحياً على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحوير في صياغتها أبداً.
إن الصياغة المعجزة للآيات التي يتكوّن منها القرآن الكريم هي التي تجعله صالحاً لكل مكان وزمان إلى يوم الدين، والصياغة المعجزة تستلزم بالضرورة أن تتمتع آيات القرآن الكريم بخاصتي الثبات والتحول معاً (الثبات في المبنى والتحول في المعنى).
وتظهر الصياغة المعجزة لآيات القرآن الكريم في أنها على الرغم من تمتعها بخاصية الثبات في المبنى التي أشرنا إليها، هي في الوقت نفسه تتمتع بخاصية التحول في معناها الذي يفهمه الناس كل حسب معارف عصره وعلومه ، وهذا هو وجه الإعجاز الأكبر لآيات القرآن الكريم الذي يجعلها صالحة لكل زمان ومكان.
إن مثل هذه الصياغة التي تتمتع بخاصتي الثبات في المبنى والتحول في المعنى معاً فوق قدرات الإنسان ، ومعارفه المحدودة بعلوم عصره ، وهذه الصياغة التي يعجز عن مثلها الناس دليل علمي قاطع على أن "مؤلفها" منْ هو أعلم من الناس وأقدر- الله تعالى.
ومن هذا الفهم لوجه الإعجاز الأكبر في القرآن الكريم، تظهر الحاجة إلى التجديد المستمر في الدراسات القرآنية، لتأويل الآيات بما يظهر صلاحيتها دائماً لجميع الأمكنة والأزمنة وفق حاجات كل عصر ، وفي ضوء المعارف السائدة فيه ، والتطور العلمي الذي بلغه.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود فرق كبير بين (التفسير) و(التأويل) فالتفسير في اللغة يرجع إلى معنى الإظهار والكشف ، أما معنى قولهم (ما تأويل هذا الكلام؟) أي (إلامَ تؤول العاقبة في المراد به؟) ومن هنا فالتأويل هو المراد بالكلام نفسه ، فتأويل الطلب هو الفعل المطلوب نفسه، وتأويل الخبر هو الشيء المخبر به نفسه.
وعلى هذا يكون الفرق كبيراً بين التفسير والتأويل ، فالتفسير شرح وإيضاح للكلام، ويكون وجوده في الذهن بتعقله، وفي اللسان بالعبارة الدالة عليه ، أما التأويل فهو الأمور الموجودة في الخارج نفسها، فإذا قيل (طلعت الشمس) فتأويل هذا هو (طلوعها نفسه)، وقد قيل : إن التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظ ومفرداتها، والتأويل أكثر ما يستعمل في المعاني والجمل.
وما دام القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، فهو لا يحتاج إلى تفسير وإنما يحتاج إلى تأويل ، والتأويل يتعلق بالاشتراك اللفظي ، والاشتراك في اللغة هو دلالة اللفظة الواحدة على عدة معان مختلفة، وميدانه الآيات المتشابهات ، أما التفسير فيتعلق بالترادف ، والترادف في اللغة هو دلالة الألفاظ المختلفة على المعنى الواحد ، إننا نرفض القول بالترادف في اللسان العربي ، وفي القرآن الكريم ، وعليه نرى أن لا ترادف بين ألفاظ القرآن الكريم، وأن كل لفظة وضعت لتؤدي معنى دقيقاً محكماً.
وهكذا يظهر أن مصطلح (التأويل) الذي يراه العامة من الناس أمراً مستهجناً ليس في الحقيقة كذلك عند أهل اللغة والرأي والبيان، بل هو أمر مطلوب. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن العلماء الأوائل سمّوا أغلب دراساتهم للقرآن الكريم تأويلاً له ، ثم جاء المتأخرون وغيّبوا من عناوين تلك الدراسات القرآنية مصطلح (التأويل) وأدخلوا بدلاً منه مصطلح (التفسير) من دون إدراك للفرق بينهما ، فصاروا يقولون : (تفسير النسفي) وعنوانه الأصلي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أو (تفسير البيضاوي) وعنوانه الأصلي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل).
إن مثل هذا التصرف برأيي إجحاف في حق القرآن الكريم واللغة والبلاغة والعلم ، وهذه مجموعة من العناوين التي تم تغييرها بإحلال لفظة (التفسير) بدلاً من (التأويل).
- "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل" للإمام جار الله الزمخشري.
- "جامع البيان في تأويل القرآن" للإمام الطبري.
- "لبان التأويل في معاني التنزيل" للإمام الخازن.
- "محاسن التأويل" لجمال الدين القاسمي.
دعوتنا إلى قراءة جديدة للقصص القرآني تستند إلى رأينا في تلازم التحدي بالإعجاز والتجديد في الدراسات القرآنية.